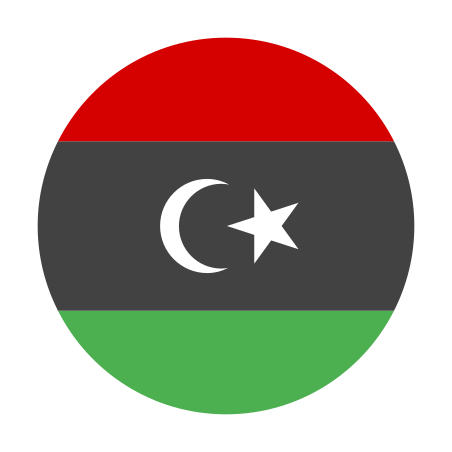روح البحث العلمي
تماما كما أن من يمارس مهنة التدريس قد يعوز الحس التربوي، وتماما كما أن رجل الشرطة قد يفتقد الحس الأمني، فإن الباحث الأكاديمي قد يفتقر إلى الحس العلمي؛ وهو يكون بهذا كمن ينظم القصيد دون أن يقول شعرا، ومن يقيم الشعائر الدينية دون أن يكون له من الخلق الحسن نصيب.
تماما كما أن من يمارس مهنة التدريس قد يعوز الحس التربوي، وتماما كما أن رجل الشرطة قد يفتقد الحس الأمني، فإن الباحث الأكاديمي قد يفتقر إلى الحس العلمي؛ وهو يكون بهذا كمن ينظم القصيد دون أن يقول شعرا، ومن يقيم الشعائر الدينية دون أن يكون له من الخلق الحسن نصيب.
يقول آلبرت أينشتاين يجب علينا أن نجعل الأمور بسيطة قدر الإمكان، ولكن ليس أبسط من ذلك؛ وفي تقديري أن من يعتقد أنه يستطيع أن يكون باحثا علميا جادا دون أن يكون لديه حدّ أدنى من الخلفية الفلسفية، إنما يجعل الأمور أبسط مما يجب. وإذا كنت لا أذهب إلى حد الزعم بأنه من لا حس فلسفيا لديه، لا حس علميا لديه، فإني أذهب إلى حد الزعم بأن الحس العلمي يقوى ويضعف بقوة وضعف الحس الفلسفي. ولعل هذا ما أراده أينشتاين من زعم آخر ينسب إليه يقول فيه "إن أقدر من لقيت من طلاب خلال مسيرتي العلمية هم أولئك الذين كانت لديهم خلفية فلسفية مكينة".
ويقول أبو حامد الغزالي، "الحق عزيز، والوصول إليه صعب، وأكثر الناس لا يرونه"؛ لعل هذا ما يجعل البحث العلمي، المعني أساسا بالسعي وراء الحقيقة، خبرة أليمة، ويجعل البحاث الجادين يجدون في عنتا ورهقا وكبدا ونصبا لا يقل عما يجده المبدعون الحقيقيون من عنت ورهق وكبد ونصب.
غير أن الحس الفلسفي ليس سوى أحد أشراط الروح العلمية، وهذه عبارة استحدثتها واقترحتها عنوانا لما سوف أتلو عليكم من خطرات، وليست مصطلحا مكرسا متوافقا عليه بين علماء المناهج. وسوف أحاول التغلب على غائمية مفهوم روح البحث العلمي بعرض مؤشرات الولاء لهذه الروح، التي تحيل بشكل غير مباشر إلى مؤشرات خيانتها.
والحال أن وصف موضع عنايتي باستخدام عبارة "روح البحث العلمي" لا يخلو من مفارقة، لأنني معني هنا أساسا بمادة البحث العلمي، والمادة ضديد الروح. غير أني آمل في صرف شبح هذه المفارقة بقول إن القياس المضمر في العنوان ليس على ثنائية الروح والمادة، بل على ثنائية روح القانون وحرفيته، وقول إن الدافع الرئيس وراء هذه الورقة هو ملاحظتي أن البحاث الليبيين دائمي الحديث عن المنهج العلمي، لكن نزر إنتاجهم للأبحاث العلمية الجديرة بهذا الوصف يسير، وهذه حقيقة يفسرها إسرافهم في الاهتمام بشكل البحث العلمي على حساب الاهتمام بمضامينه.
بيد أن الإعلاء المرجو من روح البحث العلمي لا يعني إطلاقا التقليل من شأن المنهج العلمي، فهو علامة عقلانية النشاط العلمي، وهو أحد مكونين أساسيين في تعريف هذا النشاط، حيث المكون الآخر هو غاية العلم، المتمثلة في تفسير الظواهر، وحيث المنهج العلمي هو وسيلة تحقيق هذه الغاية. باختصار، المنهج العلمي شرط ضروري وليس كافيا لممارسة البحث العلمي. ثم إن المنهجية في النهاية قوالب وأطر، وما يقولَب ويؤطَّر ليس بأي حال أقل أهمية مما يقولِب ويؤطِّر.
ولهذا فإني لا أقلل من شأن المنهج العلمي، بل أدعو فحسب إلى إجراء نوع من تغيير مركز التوكيد، بحيث نركز على منطقة دأبنا على إغفالها، دون إغفال منطقة اعتدنا التركيز عليها.
وأول مؤشرات الولاء لروح البحث العلمي أن يكون لدى الباحث حس فلسفي، وأعني بذلك أن تكون له دراية بطبيعة النشاط العلمي، وخصائص التفكير العلمي، ومسلمات العلم ومصادراته، وغاياته ومقاصده. ذلك أن من يجهل غاية العلم قد يتوسّله في تحقيق غايات غريبة عنه، ومن يجهل مسلمات العلم قد يعتقد أن العلم قادر على إثبات أن للكون نواميس تحكم ظواهره، وقد يخلط بين الاستقراء والاستنباط، وبين التبرير والتفسير، وبين القوانين الطبيعية والقوانين العلمية. ولكل يلزم الباحث العلمي الاطلاع على أقل تقدير على أساسيات فلسفة العلوم.
وثاني مؤشرات الولاء لروح البحث العلمي المزاج الارتيابي الناقد، بمعنى الاستعداد الدائم للتشكيك في الآراء الشائعة والمسلمات والبدهيات، ومحاولة حدس الفجوات المستسرة في صرح المفاهيم، والتأمل في الأفكار النادرة والغريبة والغامضة والخلافية، وعدم التسرع في رفضها لمجرد أنها نادرة أو غريبة أو غامضة أو خلافية. وعلى الباحث أن يتذكر دائما أن مبلغ ما يخلص إليه فرضية، وفي الفرضية شيء من الافتراض، فالافتراض حكم نصادر عليه دون برهنة، والفرضية حكم نخمنه بالاتكاء على شواهد لا تستنفد محتواه، بما يبقيها عاجزة عن البرهنة عليه. ولهذا يلزم البحث الإمساك عن الجزم والقطع بما يخلص إليه، مهما بدا له بدهيا ومدعاة للتيقن.
وثالثها تنكب الاستسهال، الذي يتمظهر في اختيار إشكالية بسيطة، لا يتطلب البحث فيها الكثيرَ من إعمال الفكر. وقد ينجم الاستسهال عن دراية المعني بضعف معايير التقويم، لكن هذا إنما يعني أنه لا يدرك أصلا أن البحث العلمي ليس وسيلة لتحقيق مآرب على شاكلة الترقي في السلم الأكاديمي بل تتمثل في طرح تصورات قادرة على تفسير ما نعرض له من ظواهر.
ورابعها أن يكون هناك مسار، أو نقطة عود مستمر، أو خيط ينتظم حبات عِقد البحث. كل مفكر، فيما يقول نيتشه، لديه شيء واحد يقوله، وأدعى من ثم أن يكون لدى كل باحث زعم واحد يحاول تسويغه. أما هوس الإحاطة والشمول فيناسب التقارير والكتب التدريسية، ولا يليق بالبحوث.
وخامسها انشغال الباحث بمواضع بحثه، وممارسة نوع من التبتل العلمي، بما يعكس شغفا معرفيا حقيقيا، يتمظهر فيما أقضّ مضجعه من خطرات أرغمته على التدوين في العتمات، وفي بحثه عن مفردات تنصف حسّه الجمالي دون أن تجور على دقته في التعبير، وفي اتقانه لغات أجنبية، واستيفائه استحقاقي الجدة والأصالة، وعنايته بالتفاصيل، وحرصه على التمييز بين الأماني المسرفة في التفاؤل والتوقعات المؤسسة على الشواهد؛ كما يتمظهر في استحداثه تبصرات ملهمة (inspiring insights)، وتجارب فكرية(though experiments) ، وقياسات تمثيلية(analogies) تعين على إغواء المتلقي بما حشد الباحث من أدلة على أحكامه.
وسادسها تعدد الاهتمامات وهذا مؤشر يتعلق ببينية التخصصات (interdisciplinarity)، التي تعمق فهم الظواهر، وتشترط جماعية البحث، وتستوفي استحقاق التذاوتية (intersubjectivity). ويشه على أهمية هذا التمظهر، أن المختص حين يخوض في غير مجال تخصصه غالبا ما يتخذ مواقف لا تكاد تختلف عما يتخذه رجل الشارع من مواقف. وفي هذا السياق تحضرني قولة فيليب فرانك "إن من لا يعرف سوى تخصصه جهول متعلم، وأسوأ ما في الأمر هو أن جهله يظهر بكل تبجح الرجل العالم").
وسابعها الإمساك عن الامتثال للأهواء والتشيعات، والولاء المخلص للحقيقة، وإن جاء على حساب اعتبارات ذاتية، أو طائفية، أو حتى وطنية (كثيرون منا يخلطون، وبسبل شتى، بين النضال السياسي والنضال المعرفي).
وثامنها عقد موازنة دقيقة بين الجرأة المعرفية والحياء المعرفي، بين القرينية (Evidentialism) والدحضوية (Falsificationism)، بحيث نتجنب الشطط في الأحكام من جهة، وتحوز نتائجنا قدرا كافيا من الأهمية من أخرى.
وتاسعها التناول المعمق للقضايا، وعدم التشبه بالعلوم الطبيعية من خلال ما يمكن وصفه بالإمبيريقية الفجة، التي تشي بنظرة دونية للعلوم الإنسانية لدى حتى الباحثين فيها، بما ينبئ عن تغاض عن حقيقة أن عقلانية العلم لا تكمن في إمبيريقية منهجه بل في كونه أنجع السبل المتاحة لاختبار فرضياته.
وعاشرا وأخيرا، تطوير حساسة مفهومية (القدرة على استشعار الفروق بين المفاهيم المتشابهة)، وأخرى لغوية (القدرة على استشعار الفروق بين عبارات قريبة الصلة)، وثالثة منطقية (القدرة على تجنب الأغاليط والحجج الفاسدة). وهذا يعني أن الباحث العلمي لا يحتاج فحسب إلى خلفية في فلسفة العلوم، بل يحتاج أيضا إلى دراية بآليات التفكير الناقد التي تسهم في إرهاف حساساته الإدراكية وصقل مهاراته الجدالية.
يقول فيليب فرانك إن العلم "هو المتصدي لتحرير العقل البشري من خرافات تجذرت فيها ممارسات همجية ومخاوف قمعية، وهو المسؤول عن رفع الغطاء الأمني الذي يؤمنه التخلف للإجحاف الاجتماعي، وهو المسؤول عن تطوير مزاج ارتيابي إزاء المعتقدات التقليدية".
هذه ليست أهداف العلم لكنها ظواهر مصاحبة لتحقيق أهدافه، وهي مقاصد يفترض أن يحققها البحاث في المجال العلمي. فهل حقق البحث العلمي في بلادنا أيا من هذه المقاصد؟ وهل أنجز بحاثنا أي نقلات معرفية جديرة بالتنويه؟
في تقديري أن الثقافة العلمية لم تتأسس بعد بلادنا، والدعوة إلى توطين العلم دعوة وجيهة، مادامت تؤكد تأدية مهمة العلم الأساسية، والإمساك عن تغرض أي مقاصد قيمية، والولاء لروح البحث العلمي بدلا من الاقتصار على تأدية شعائره.
ولأن روح الفيزيائي، فيما يقول كلود بنار، تختلف عن روح الكيميائي، وروح المؤرخ تختلف عن روح اللغوي، فأن أفضل من يحدثنا عن روح أي علم بعينه هو المختص المتفوق فيه، الذي أمضى نضير العمر يسبر أغواره، ويذود عن حياض دياره، حتى عرف منابع أنهاره، وذاق من فيض أسراره. وما كان القصد مما أتيت على ذكره من خطرات سوى أن يقوم من يأنس في نفسه الدراية بروح تخصصه، أو لنقل من يأنس في نفسه الدراية بأسرار مهنته، أن يدير حلقة نقاش يحدثنا فيها عن مكامن قوته ومواطن ضعفه، وعن أهم المدارس الفكرية التي تنازعت توجهاته، وعن السمات الإبداعية التي ميزت أعلامه، وعن صلته بتخصصات أخرى قريبة النسب، وما عنّ له من تجليات أخرى لروح هذا العلم، عساه يسهم في خلق جيل أقدر على إجراء أبحاث علمية جديرة بهذا اللقب.
ولعلي أجد روح البحث العلمي في المثقف الليبي أكثر مما أجدها لدى الأكاديمي الليبي، فالأفكار العميقة، والتبصرات الملهمة، وتعددية التخصصات، والانشغال الطوعي والحقيقي بمواضع البحث، والدراية بحدود العلم، أوفر حظا لديه منها لدى الأكاديمي. صحيح أنه لا يولي الجوانب الشكلانية للبحث الاهتمام الذي يليق بخطرها، لكن الاستحقاقات الشكلانية تظل في النهاية أيسر على الإيفاء.
ودعوني أختتم بحديث عن مستوى آخر للإسراف في الاهتمام بالشكليات، أجده تحديدا فيما يبذل في مؤسساتنا الأكاديمية من جهود ومساع تستهدف تطبيق معايير الجودة، وسوف أكتفي بالسؤال عما إذا كانت هذه الجهود والمساعي قد حققت مبتغاها، وما إذا كانت إدارات الجودة ومكاتبها، ومديروها ومنسقوها، وندواتها ودوراتها، ونماذجها ومنشوراتها، قد أسهمت في تحقيق أي درجة من الارتقاء الأكاديمي. صحيح أنه ليس لأحد أن ينكر أنها أسهمت في تحقيق ارتقاء في التصنيفات العالمية، لكن هذا يثير عما إذا كان هذا الارتقاء السيبرنتي ينعكس بأي وجه في واقع النشاطين التدريسي والبحثي، وما إذا كنا بالمشاركة فيها نتواطأ في ممارسة نوع من التضليل وفي خلق مزيد من الأوهام.