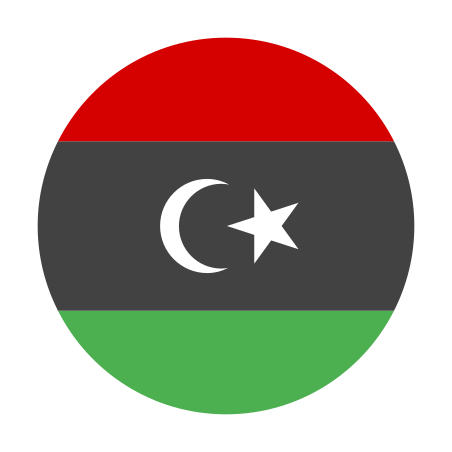تحجر المفاهيم: القبيلة والمجتمع ودولة القانون
تسعى هذه الورقة لإعادة التأمل في بعض المفاهيم العالقة بالذهن والجامدة في التاريخ، والتي تحولت مع الوقت إلى نوع من التهم، أو الحكم القيمي المسبق دون الانتباه لبعدها التاريخي والاجتماعي، ولِما طالها من تغيرات فرضها ضغط التكيف مع نتاجات العصر واستحقاقات المنافسة، و (القبيلة) من هذه المفاهيم التي جُمدت في إفريز القاموس السياسي وتستخرج كل مرة في سياق توجيه اصبع الاتهام لها كلما حدثت معوقات أو أزمة أو مظاهر تخلف، إضافة إلى الربط العضوي الدارج بين القبيلة والبداوة كبنى طاردة لفكرة الدولة المدنية ولدولة القانون والجدارة.
أحاول أن أخفف من السعار الموجه تجاه القبيلة والقبلية كأدوات معطِّلة لبناء الدولة أو للشروع في مستقبلها الديمقراطي، لأن هذا التشخيص ربما يكون خاطئا أو على الأقل غير دقيق. بمعنى أننا حين نركز على هذا الجانب قد نغفل عن جوانب أخرى أكثر تأثيرا وخطرا، مثلما يحدث في التعامل مع مرض السرطان مثلا، فكل التحذيرات تتوجه إلى التدخين وكأنه السبب الوحيد أو الرئيس للإصابة به، بينما أظهرت الدراسات أنه أحد الأسباب من جملة أسباب أخرى أكثر خطرا وأقل التفاتا لها، مثل الدهون والمواد الحافظة والمبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية والزيوت المهدرجة وعوادم السيارات والمصانع ... إلخ، ويثبت هذا أن سرطان الرئة الذي يسببه التدخين أقل إحصائيا من أنواع السرطانات الأخرى، وأن معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء غير المدخنات أضعاف أضعاف الإصابة بسرطان الرئة الناتج عن التدخين، لكن الناس الذين تم توجيه اهتمام أبصارهم صوب التدخين كسبب رئيس للسرطان، يغفلون عن الأسباب الأخرى الأكثر خطرا.
هذا مثال قد يساعد في ما يتعلق بتشخيص الأزمة أو المشكلة، ولكن فلنحور هذا المثال بشكل قد يفيد من زاوية أخرى: ثمة غير مدخنين أصيبوا بسرطان الرئة (ونحن مازلنا في صدد التمثيل على التركيز على القبيلة والقبلية كسبب وحيد للأزمة) دون أن يكونوا مدخنين، ويُرجع المختصون هذه المشكلة لما يسمى التدخين السلبي، بمعنى التدخين غير المباشر عبر وجود الشخص وسط مدخنين واستنشاق الدخان دون أن يقصد، وهذا ينطبق على القبلية ــ إذا ما اعتبرناها افتراضا سبب المشكلة ــ بتأثيرها السلبي أو غير المباشر، بمعنى أن ثمة من لا ينتمي لقبيلة ولا يمارس القبلية بشكل مباشر، لكنه يُحّول جماعته الجديدة : حزب أو منظمة مدنية أو حكومة أو شركة، إلى قبيلة ــ وقد يقال لا بأس مادام انتمى لقبيلة مختلفة لا تربطها علاقات الدم، وهذا ما جعلنا نرفع في فترة لافتة تقول (ليبيا قبيلة واحدة) في ظل شعارات تزدري القبلية من أساسها ــ وهنا يتضح المقصود بالقبلية السلبية التي وضعناها في مقابل التدخين السلبي، فلا تكمن المشكلة في كون شخص جعل من انتماءٍ جديد قبيلَته، لكن في كونه يديرها بعقلية القبيلة أو بأسلوب قبلي (وأنا هنا أقصد بعقلية القبيلة الرعوية التقليدية التي ما عادت موجودة بهذا المفهوم) والتي كانت مترحلة لا تستقر، وفيها الشيخ شيخا مدى الحياة، ولابد أن تطاع أوامره، والمشيخة وراثية غالبا، وما يفعله الشيخ بشكل منفرد ينسحب على كل القبيلة، وهي المواصفات التي من الممكن أن تنطبق على رئيس أو مؤسس الحزب، أو رئيس المنظمة المدنية، أو رئيس الحكومة، أو رئيس السلطة النيابية، أو مدير الشركة أو المصنع أو حتى الجامعة، وعلى الرغم من تغير بنية القبيلة التقليدية ومنظومة العلاقات داخلها، وتغير شيوخها الذين أصبح بعضهم حاصلا على شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع أو القانون، وتغيرت عقيدة أعضائها ومصادر معرفتهم ، إلا أن أسلوبها القديم المنمط يصبح العقلية التي تدار بها المؤسسات المعاصرة، بما يشبه الحزب السياسي الذي يتبنى عقائد دينية عتيقة رغم أنها تغيرت حتى داخل المؤسسة الدينية التي تخرج منها. (حزب النهضة كمثال في تونس وتخلفه عن جامعة الزيتونة).
القبيلة، البداوة، أو مايشتق منها من مفردات تتوجه في مجملها لوصف حالة رجعية من التخلف الذي يناهض الحداثة، بدأت علكة دائمة نستخدمها دون أن نتوقف عند ما طرأ من تبدلات جذرية في هذه المفاهيم، وقد أتيح لي أن أعيش حياة البداوة في قلب القبيلة وأن أعيش في المدينة في قلب الحاضرة، وكنت ألمس تلك المتغيرات في هذه المفاهيم التي تتناغم مع وتيرة سريعة في التقنية والحضارة والتواصل، حيث مفهوم القبيلة في الاقتصاد الرعوي او الزراعي البعلي تغيرت تماما بعد النفط وما ترتب عنه من إعادة علاقات إنتاج وانسياب خدمي حضاري طال المناطق المعزولة والنائية، وحيث مفهوم البداوة تغير مع شبكة المعلومات والمعرفة التي اجتاحت كل الجيوب المعزولة في العالم، مثلما فعلت يوما الطرق المعبدة والقطارات في تغيير وتطوير هذه البنى حين تواصلت مع المدن بفهموما الميتروبوليكي المصدر لقيمها للمحيط عبر أدوات الاتصال والتواصل هذه.
شُتمت القبلية وخُوِّنت في السنوات الأولى من حكم الانقلاب، ثم عادت في ثوب الولاء الأيديولوجي وعبر تحالفات يحكمها "الولاء الثوري"، وعبر أشخاص يحررون وثائق المبايعة للقائد، هم في الواقع لا يمثلون قبائلهم التي لا تستطيع التبرؤ من مواقفهم في ظل العسف، وهذا التوظيف السيء مع جعل البدونة شعارا للنظام السابق ومؤسساته وحتى فنونه، خلَطَ بين القبيلة والأيديولوجيا، على الرغم من أن القبيلة نفسها تقوضت بداوتها مع دخول تقنيات العصر ومعارفه، وأشهرت الخطاب الأيديولوجي الخيمة في وجه القصر، مع أن العصر كان يسمح بأن تتحول الخيمة إلى قصر وليس العكس، مثلما بنت المجتمعات المتحضرة قصورا للمزارعين وزودتهم بكل وسائل التقنية والمعارف حين قررت المدينة أن تصدر نفسها للمحيط، لا أن تنطوي وتزدري هذا المحيط الحيوي والضروري للتنمية والتعايش وبناء الدولة، وتكيل له الاتهامات وكأنه خطر من أخطار الطبيعة.
في فترة النظام السابق أدمجت الولاءات القبلية في أيديولوجيا الحاكم كتكنيك للتمكن من السلطة، واستغل انتهازيو القبائل هذا الظرف، مثلما حدث بعد ثورة فبراير، حيث هيمنت أيديولوجيا الإسلام المسيس على المشهد. وإذا ما لمسنا مظهرا لتراجع السلطة الهرمية للقبيلة، أو نظامها الأبوي التقليدي، باعتبارها منظومةً اجتماعية مرنة يطالها ما يطال المجتمع من تغيرات ويمكن استيعابها في مشروع الدولة الحديثة، فإن ما يسمى الإسلام السياسي بكل تفرعاته يشكل لب النظام الأبوي أو الهيراركي المضاد بنيويا للديمقراطية وللحداثة، فهي منظومات أصولية متعصبة وجامدة، ويشكل الأمر والطاعة جوهر عقيدتها. وهذا ما يجعل اتهام هذا التيار للقبيلة بأنها معطلة للديمقراطية مفارقةً ونوعا من التعمية، ويشبه توجيه النظر إلى (التدخين كخطر وحيد).
من ناحية، أصبح العداء الموجه للقبيلة أو البداوة من منطلق ردة فعل ضد لافتات النظام السابق التي لا تعكس الواقع الاجتماعي، ومن ناحية أخرى، أصبح هذا الخطاب الموجه ضد القبيلة والبداوة خطابا استعلائياً شبيها بالخطاب الاستشراقي (وأعني الاستشراق الدوغمائي الموجه وفق أحكام مسبقة وليس العقلاني الباحث عن المعرفة) والمفارق اننا جميعا في الشرق أو في الجنوب يضعنا هذا الخطاب الاستشراقي في سلة واحدة محتواها تخلف وبداوة، بباديتنا وريفنا ومدننا وحواضرنا وصحرائنا، بمعنى أن هذا الخطاب التمييزي ينتقل من مستوى إلى مستوى كما هي عادة الخطاب العنصري، فالمديني الذي يصف القرية المجاورة بالتخلف، هو متخلف بنسبة لمديني آخر في الشمال وهكذا.
القبيلة مسألة وجودية لهذه المجتمعات، متجذرة من قرون طويلة وستستمر مادامت البدائل غير متاحة، والسياسة الرشيدة هي التي ترسم خططا لإدراة خصائص المجتمعات وطبائعها وليس لمسخها عنوة وعبر الشعارات، مثلما فعلت الشيوعية المتطرفة مع الأديان والمذاهب والمعابد، ووضعتها في سياق الماضي الواجب انقراضه في الأراضي التي سيطرت عليها، وهي تحاول أن تنزع أمما كاملة من خصائصها الروحية، ومن تقاليدها الدينية والعرفية، ومما يشكل محور هويتها ووجودها، وبمجرد أن تفككت هذه المنظومة الماسخة لهوية الكائن الإنساني، عادت تلك الخصائص الروحية والعرقية تعلن عن نفسها من جديد. ولقد راعت دولة الاستقلال في ظل الحكم الملكي هذه الخصائص في الكثير من سياساتها الإدارية والاجتماعية، وعلى سبيل المثل رسمت حدود المحافظات الإدراية وفق التركيبة القبلية غالبا، ولكن هذا لم يمنع الشروع في إقامة دولة قانون ومؤسسات متسقة مع ذلك العصر، وإفراز أجسام نقابية وطنية مهمة، كنقابة العمال وأتحاد الطلاب، مع تحفظ يسجل حيال منع الأحزاب الذي بُرر في ذلك الوقت بكون أنوية الأحزاب تمثل فروعا لأحزاب خارج الحدود وليست نتاجا وطنيا محليا. مثل الأحزاب القومية والأخوانية والبعثية والشيوعية. وقد وصلت هذه التيارات في دول أخرى إلى السلطة وخسفت بالديمقراطية وبالحقوق ونكلت بشعوبها. ونشرات الأخبار الحالية تنبئنا بهذا المصير. ولكن في المحصلة لا تقوم ديمقراطية ــ حتى الآن ــ إلا على حياة حزبية، شرط أن يكون العقل الديمقراطي متجذرا في ثقافة هذه الأحزاب، والأمر مازال معقدا بالنسبة للدول المقلدة لهذا النموذج العالمي.
أُتيحَ لي أن أعيش الحيوات المختلفة، البادية والقرية والمدينة، وأستطيع أن أقول أني وقفتُ على أن كل هذه الثقافات متكاملة وليست متضادة كما يروج لها الآن، وأن ما ينقص هو إدارة هذه العلاقة التكاملية بينها، وأن لا تُختزل في تأويلها السياسي، أو في ظرفها التاريخي الخاص الذي خلق هذه الهوة بناء على إدارة سيئة لهذه العلاقة، خَدَمَتْها ظروفُ الاقتصاد الريعي، وطبيعة الحكم الشمولي الذي طالما هجته قصائد وأغان شعبية بدوية في زمن الصمت والطاعة، وتمخض عن هذه الهوة نوع من العنصرية التي أحالت كل ثقافة إلى قدر جيني تحول فيها مكان مولد الشخص ولقبه إلى معطى ثابت للحكم عليه واتخاذ موقف منه، وقد عايشت هذا الخلل الذي اعترى المفاهيم وحوَّلها إلى شعارات صادحة أو شعائر لا يمكن دحضها بأي محاولة لتجاوز هذا الترسيم.
قبل اكتشاف النفط وتصديره، وقبل أن تدير المدن ظهرها للمحيط عندما أصبح كل الغذاء يأتي من البحر، كانت العلاقة تبادلية وسوية حين كانت مقايضة السلع بين المدن ومحيطها أمرا ضروريا لاستمرار الحياة للاثنين، كما عايشت رغبة المدينة في تصدير قيمها الثقافية إبان الستينيات حين كانت المكتبات والسينما المتنقلة تصلنا في القرى والنجوع، وحين انتشرت المدارس والأقسام الداخلية والآلات والخدمات الصحية في الدواخل، لكن ما حدث بعد ذلك من تكديس الثروة النفطية وتحويلها إلى مرتبات في المدن، تسبب في نزوح جماعي صوب المدن أضر بالاثنين، ثم بدأ النظام الجماهيري حربه على المدينة في سياق حربه على مفاهيم النخبة والكفاءة، وانتهى بقذع وشتائم للمدينة وسكانها في إحدى القصص التي كتبها الحاكم في إطار استراتيجية بدْوَنة الدولة التي كانت شعار النظام السابق الصادح، ما جعل البعض يختزل البداوة في هذا السياق الضيق حتى يومنا هذا، مع أن هذا المفهوم تبدل بالكامل بعد تسويق النفط، وما تلاه من انسياب للمعرفة عبر الأقمار الصناعية، والمجتمع الرقمي الذي أصبحنا شئنا أم أبينا جزءا منه حين تحولت هذه الثورة التقنية إلى نظام شامل للترويج والتسويق: تسويق كل شيء، من السلع إلى الثقافة إلى الدين إلى النموذج.
ولمحاولة فهم هذه المتغيرات الجذرية، ودحضِ مسلّمة أن القبيلة ضد الدولة الحديثة والمدنية، سأذكر مفارقتين، إحداها حصلت في السنوات القليلة الماضية ومازالت تحصل، والأخرى حدثت إبان تأسيس الدولة الوطنية في منتصف القرن الماضي:
أحتفظ في أرشيفي الخاص بالكثير من البيانات التي صدرت بعد فبراير من اجتماعات قبلية، ومن بيانات صدرت من قلب الحواضر المدنية في ليبيا، وأقبض على مفارقة غريبة، فجل البيانات القبلية تحرص على وحدة الكيان الليبي، والحفاظ على المسار السياسي بعد الانتخابات، وعلى مدنية الدولة، بينما بعض البيانات (الفتاوى) التي صدرت من حواضر مثل درنة أو بنغازي أو طرابلس أو صبراتة أو مصراتة كانت تكفر الديمقراطية والدولة المدنية من الأساس، أو تدعو في أفضل الأحوال إلى دولة دينية تُحكِّم شرع الله. وأعرف أن هذه المفارقة خاضعة لظرف شاذ وليست راسخة اجتماعيا أو ثقافيا، فقط لأن تلك الحواضر سيطرت عليها لفترة جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وهي حقا لا تعكس روح تلك المدن التي لها باع طويلة في الثقافة والسياسة، والتي أسهمت بقدر كبير في تأسيس أول دولة وطنية مدنية في ليبيا. لكن السؤال هو كيف استطاعت هذه الجماعات الظلامية أن تسيطر بسهولة، أو بغير سهولة، على تلك الحواضر النابضة؟ ولماذا غابت لفترة التيارات المدنية والوطنية فيها، بين صمت وحياد أو نزوح خارج المدن.
هذه المفارقة الناتجة عن ظرف طارئ تمُتُّ بصلة إلى مفارقة حدثت قبل سبعين سنة ناتجة عن ظروف مختلفة، إبان الشروع في تأسيس دولة ليبية مستقلة لأول مرة وفق قرار من الأمم المتحدة وبدعم منها، حيث يذكر مبعوث الجمعية العامة، أدريان بيلت، أنه في التجهيز لصياغة دستور الدولة تطلَّبَ الأمر وجود هيأة لصياغته، ما سُمي فيما بعد "لجنة الستين"، وحدث الاختلاف الجوهري بين من يطالب بانتخاب هذه الهيأة وبين من يصر على تعيينها، والمفارق أن الأحزاب الناشطة في طرابلس ــ كما يروي بيلت ــ كانت مع التعيين وضد الانتخاب، إضافة إلى النخبة الحاضرة من الشرق وجلها من بنغازي والفاعلون فيها معظمهم أعيان مدن أو تكنوقراط عائدون من المنفى، كانوا يميلون لآلية التعيين، غير أن الطرف الثالث المتمثل في فزان كان رافضا لفكرة التعييين بشدة، مؤكدا على ضرورة انتخاب أعضاء لجنة الستين، مع العلم أن ما يمثل فزان في تلك الفترة هو تجمع قبلي يقوده السيد أحمد سيف النصر الذي كان لا يقبل نقاشا في ما يخص انتخاب الهيأة، ما عرقل الشروع في صياغة الدستور إلى أن تدخل الأمير السنوسي لإقناعه. وهي مفارقات تطرح أسئلة حيال مفهوم القبيلة ومفهوم الأحزاب الذي مازالا في جدل حتى وقتنا الراهن. فالأحزاب ضرورة لأي ديمقراطية، ولكن ليس بالضرورة القبيلة معرقلة للحلم الديمقراطي.
القبيلة كيان اجتماعي راسخ منذ قرون، وتمتد جذوره في مكونات المجتمع الليبي،، الأمازيغي والعربي، وتحضر القبيلة بقوة إذا ما تراجع الدور المؤسسي في الدولة أو غاب إنفاذ القانون وكأنها سيناريو بديل في حالة غياب هذه الشروط المدنية للحفاظ على الترابط والسلم الأهلي، وطبيعة العمل السياسي أنه يحتاج إلى مجموعات، وحين تغيب المجموعات البديلة يتراجع المجتمع تلقائيا إلى مجموعاته التقليدية، ورغم ذلك، إذا ما تمعنا في كل الانتخابات التي حدثت بعد ثورة فبراير، والأسماء التي تصدرت المشهد عبر مبادرات للمجتمع الدولي، فلن نجد للقبيلة دورا واضحا أو أثراً فيها، من أعضاء المجلس الانتقالي ورئيسه، إلى آخر قائمة للسلطة القائمة حاليا. فأول انتخابات جرت في درنة، مثلا، وعايشتها العام 2012: لم تتدخل فيها القبيلة بأي شكل من الأشكال، كانت الانتخابات وفق قوائم حزبية وأفراد، كما في كل ليبيا، وتشكلت أول سلطة تشريعية منتخبة عن طريق القوائم الممثلة لتيارات سياسية وليس قبلية، وهي الهيمنة الحزبية نفسها التي اتخذت فيما بعد، وللأسف، قرارا بغزو قبيلة لقبيلة أخرى من أجل تصفية حساب قديم.
وحين بدأ الإعداد لانتخابات المؤتمر الوطني في دائرة درنه، كنت أخشى تطفل القبيلة على العملية الانتخابية مثلما كانت تفعل في آخر تصعيد جماهيري، لكن ما شد انتباهي غيابها الكامل عن التأثير في هذا الاستحقاق، وكأن شعورا تسرب إليها بأن مهمتها التي كانت تمارسها في غياب البدائل انتهت، وأنه حان الوقت مع هذا التغيير الجذري للنظام للبدائل كي تستلم المستقبل، ومع إخفاق البدائل او انحرافها عن مهمتها: الأحزاب الهشة التي شكلت كما تُشكَّل التشاركيات التجارية، والمنظمات المدنية التي انهمك معظمها في البزنس على حساب دورها المدني، هيمن تيار الإسلام السياسي، المتناقض بنيويا مع المناخ الديمقراطي، على الجسم المنتخب رغم خسارته للانتخابات عبر تكتيكات مختلفة تتعلق بصياغة قانون انتخابات يخدمه، أو عبر المجموعات المسلحة، والإعلام التعبوي، والإغراء والابتزاز والاغتيالات، مثلما كان يفعل النظام السابق لفرض أطروحته. ومن جديد عادت القبيلة في مواجهة هذا التيار، ولتملأ الفراغ في غياب التيارات المدنية الفاعلة عبر إجراء المصالحات الاجتماعية للحفاظ على السلم الاجتماعي، أو عبر الدخول في تحالفات عسكرية لمواجهة أذرع هذا التيار الفاشي المسلح وجماعاته الإرهابية، دون أن تتخلى بيانات اجتماعاتها على الدعوة للعودة إلى المسار السياسي للدولة المدنية (وهذه المرة الثانية التي تتحالف فيها القبائل في غياب البدائل ضد فاشية غازية).
حين نجرد كل السلطات التي تصدرت المشهد في هذه العشرية وآليات وصولها للسلطة، نجد أن انتخابات مجلس النواب لم يكن فيها للقبيلة دور بارز رغم إلغاء آلية القوائم، وانتخاب عقيلة صالح رئيسا للبرلمان كان عن طريق أعضاء مجلس النواب الذي يشكل فيه الأغلبية أعضاءٌ من الغرب والجنوب ولم تكن القبلية منطقيا وإحصائيا وراء هذا الانتخاب.
السلطات التي نتجت عن الاتفاق السياسي في الصخيرات، السراج وباقي رؤوس المجلس وما سمي حكومة الوفاق الوطني، لم يكن للقبيلة دور فيها.
قائمة المنفي وادبيبة لم تصل عبر أي تدبير قبلي، ولكن كان وراءها رجال الأعمال أو المال السياسي. وهي الأجسام التي تصدرت المشهد وأخفقت في الرسو بليبيا على بر الأمان والشروع في تأسيس دولة، ورغم ذلك تظل التهمة موجهة للقبلية جزافا كمشجب علّقت عليه النخب الفاشلة إخفاقاتها المتتالية.
غير أنه بمجرد أن ظهر فراغ سياسي ولم تستطع الأحزاب الهشة ملء هذا الفراغ، ما عدا ذراع الإسلام السياسي، لا أقول عادت القبلية، ولكن عادت الجهوية والمحاصصة الإقليمية، والتي تحفزها أسباب أخرى تاريخية واجتماعية وإدارية، لكن لا يمكن أن نخلط بين الجهوية والقبلية، فالشرق مثلا يتكون من قبائل من جميع أنحاء ليبيا، بينما المقاطعة أو الانقسامات داخل مجلس النواب، كانت وراءها في الغالب أسباب أيديولوجية في الأساس وظفت فيما بعد المشاعر الجهوية.
وحين أقول أيديولوجيا، أعني الإسلام السياسي المنظم بكل أذرعه، وهو التيار الذي هاجم بضراوة القبيلة والجيش منذ البداية لأنه يراهما العائقين امام مشروعه في التمكين الذي فشلوا فيه عبر الانتخابات، واستطاعت وسائل إعلامهم وجيوشهم الإلكترونية أن تؤثر في قطاع واسع (حتى من بين المثقفين)، عبر استخدامهم لهذه اللافتات كمسبات تقف عائقا أمام الدولة المدنية، بينما تيارهم هو صُلب النظام الأبوي التراتبي الذي يشكل عائقا حقيقيا أمام الديمقراطية (وحتى مصطلح الدولة المدنية دخل القاموس السياسي كبديل للدولة الدينية أو الكنسية التي كانت مسيطرة في أوروبا). ونهج الإسلامي السياسي نفسه النهج الذي تبناه القذافي في بداية طرح أيديولوجيته، حيث تحول اصطلاح ا(لقبلية) إلى ما يشبه الشتيمة ثم التهمة، وأيديولوجيا الإسلام السياسي فعلت المثل، وكلاهما عاد في النهاية لمحاولة خلق تحالفات قبلية للحفاظ على السلطة. وفي الحالتين كان من يمثل القبائل في تحالفها مع السلطة بعض الانتهازيين أو الميليشيات غير المحسوبة على قبائلها، والظرف دائما مرتبط بهيمنة السلاح والمال الفاسد، وهو ظرف تراجعت فيه القبيلة حتى عن ممارسة دورها القديم في المصالحة والحفاظ على السلم الاجتماعي.
لا يمكن بناء طوابق سياسية أو مدنية إلا فوق أرضية اجتماعية درسناها وفهمنا تحولاتها ومدى استعدادها لهضم استحقاقات الدولة الجديدة، لتكون هذه المتغيرات حافزا لبناء دولة مدنية وليست عقبة ترمي بنا لليأس من المستقبل، ولعل عالم الإنترنت الذي دخل كل الجيوب المعزولة مثلما دخل الموبيل جيوب الفلاحين ورعاة الماشية، يبني نوعا جديدا من العلاقات، ووعيا مختلفا يجب أن ننتبه له ونُسخّره لخدمة أحلامنا في أن نكون جزءا من العصر، فكل مشترِك في منصة تواصل اجتماعي أصبح أصدقاؤه في هذه المنصة من أصقاع الأرض هم قبيلته التي يتواصل معها ويتابع أخبارها يوما بيوم. أما ربط الاستقطاب الجهوي، وما تمخض عنه من مركزية، أو دعوات لنظام فيدرالي، أو نزوع متطرف لتوجهات انفصالية، فهو أمر معقد عابر للقبيلة ومرتبط بشجون تاريخية وثقافية وجغرافية طاعنة في الزمن، كان محور الجدال إبان تأسيس الدولة الليبية بداية الخمسينيات، وكان منبعا للمخاوف للنظام السابق الذي كان يعتبر شرعيته نابعة من الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحذّر من تقوض هذه الوحدة إذا ما أطيح به، كما كان هاجسا خفيا يعكر صفو ثورة فبراير برزت في مواجهة وسواسه مقولات وهتافات وشعارات وحدوية متحمسة، من ضمنها مقولة "ليبيا قبيلة واحدة" التي انتشرت على كل الجدران بجانب "لا للقبلية"، بل أن القذافي جعل من ليبيا قبيلة واحدة ليكون شيخها، غير أن الهواجس السابق ذكرها لم تختفِ حتى في ظل الغزل المتبادل بين الأقاليم والمدن الرئيسة، وكانت تبتلعها في البداية حمى ثورية تسعى لنزع ليبيا من مخالب النظام السابق، ومع انتهاء أعراض هذه الثمالة الثورية، بدأت هذه الهواجس تعمل وتنشط من جديد مثلما حصل في فترات تغيير أو انتقال أو تأسيس سابقة، لذلك يجب أن نعرف أن ليس للجهوية أو الإقليمية علاقة بالقبيلة أو القبلية، ومن ناحية أخرى لن يجدي إنكارها، لكن يجب التعامل معها بإستراتيجية مناسبة، تفرغها في دستور توافقي وتشريعات وقوانين تخفف من غلوائها، لأن مبدأ الانصهار الوطني لا يمكن أن يتحقق إلا مع إنفاذ ميثاق وطني يضمن التعايش واللامركزية ويتيح الفرص للجميع، وإطلاق برامج تنمية مكانية مستدامة، وبناء جهاز إداري فعال لهذه الخصوصيات التي يتميز بها المجتمع الليبي، بما فيها الإثنيات التي مازالت تُقصَى من المشهد في سياق إقصاء التعددية كمبدأ يضمن التعايش الليبي والمشاركة.
فتح فضاء يستوعب التعددية وهذه المكونات التي تنضج مع الوقت، وفحص المتغيرات العميقة في المجتمع، وإدماجها في متطلبات العصر، أفضل من تخوينها أو شتمها أو وضعها خلف الأداة النافية (لا).