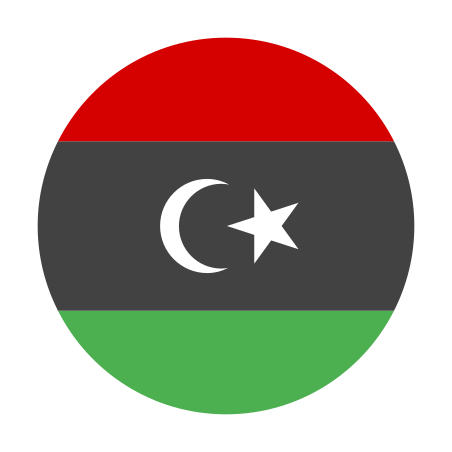بناء الدولة والتعايش السياسي والمجتمعي في ليبيا
تهدف هذه الورقة إلى التركيز على أثر أزمات بناء الدولة ومعالجة قضايا المرحلة الانتقالية والعملية الدستورية على التعايش السياسي والسلم المجتمعي في ليبيا. وسوف تحاول الورقة دراسة التحديات التي تواجه التعايش المجتمعي والسياسي الناجمة عن أزمة بناء الدولة والتحول الديمقراطي في ليبيا بعد السابع عشر من فبراير 2011 وانعكاس التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظام السياسي الليبي منذ الاستقلال عام 1951 على هذه التحديات والأزمات. ويتعين في البداية التعرض لمفهوم التعايش بشكل مختصر.
يعني التعايش في جوهره تعلم العيش المشترك وقبول التنوع، والسمة الرئيسة في تعريف التعايش هي العلاقة مع "الآخر" والاعتراف بوجوده، حيث إن الاعتراف المتبادل شروط ضروري للتعايش المشترك، سواء على المستوى الفردي أم المجتمعي أم السياسي. ولقد برز مفهوم "التعايش السلمي" أولا في إطار العلاقات الدولية والصراع بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية خلال خمسينيات وستينيات القرن الفائت. ويستند على الدعوة لأن يكون الصراع بين القطبين المتنافسين صراعا سلميا ولا يتم اللجوء إلى استخدام القوة والحرب. وهو يرتكز على الأسس التالية: الاحترام المتبادل لسيادة الدول وسلامة أراضيها؛ وعدم الاعتداء؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ والمساواة؛ وأخيرا المصالح المتبادلة.
وبالنظر إلى واقع الانقسامات والصراعات العرقية والطائفية والقبلية والجهوية والسياسية في عدد كبير من دول العالم المعاصر، وتأثير هذه الانقسامات والصراعات على الاستقرار المجتمعي والسياسي وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فقد تنامت الأدبيات التي قامت بتطبيق مفهوم التعايش على العلاقات بين مكونات المجتمع الواحد والدولة الواحدة. وعلى هذا الأساس، أصبح التعايش أحد مرتكزات الدولة المدنية الديمقراطية، وعنصرا جوهريا في بناء السلم والأمن المجتمعي والأهلي.
ويتعين التعايش في اكتشاف المساحات المشتركة بين الأطراف المختلفة، وهذه المساحات المشتركة تمثل الجسور الممتدة ونقاط اللقاء بين كل الأطراف. وبهذا المعنى، فإن التعايش مساحة اجتماعية مشتركة بعيدا عن نزعات الاستحواذ والإقصاء وعن محاولات جعل المجال العام حكرا على طرف من الأطراف، وحيث يكون التفاعل مؤسسا على قاعدة احترام التعدد والاختلاف التي تعني، في إطار المجال العام، العيش المشترك والمتساوي بين جميع الأطياف. ولكن هذا لا يعني أن من شروط التعايش "أن يتخلى أحد الأطراف عن قناعاته الفكرية لصالح قناعات الطرف الآخر، بل أن يذهب الجميع إلى المساحة المشتركة ويوظف قناعاته وخصوصياته الثقافية للمساهمة بإيجابية في إثراء المساحة والمجال المشترك". (محفوظ)
ويستلزم التعايش السياسي تطوير نظام الحكم ومؤسساته وقوانينه بحيث يمكنها استيعاب أشكال التنوع والتعدد الاجتماعي والسياسي، وتعزيز حظوظ التعايش المجتمعي والسلم والأمن الأهلي. وهذا يعني البحث عن أشكال الحكم الدستورية التي تتنوع من الإدارة المحلية إلى الحكم المحلي إلى الفيدرالية وإلى حتى الحكم الذاتي، وعن أنواع النظم الانتخابية، التي تستجيب لمقتضيات التنوع والتعدد الاجتماعي والسياسي بصورة أفضل وبما يخدم التعايش السلمي في المجتمع والدولة. بعبارة أخرى، "لا يمكن أن يوجد تعايش حقيقي دون وجود دولة قادرة وفاعلة، لكونها المؤسسة الرئيسة المنوط بها تنظيم العلاقات في المجتمع بمختلف مناحيها، وبسط سلطة القانون بالتساوي، وصياغة مشروع وطني جامع لكل الأطراف والمكونات". (محفوظ)
• تحديات التعايش في ليبيا: أزمة بناء الدولة
منذ خمسينيات القرن العشرين، شغلت قضايا التخلف والتحديث والتنمية حقل السياسة المقارنة، وتعددت وتباينت مقاربات دراسة التنمية السياسية بتعدد وتباين المنظورات الفكرية لأنصار هذه المقاربات، بحيث أصبح هناك منظور ليبرالي للتنمية ومنظور محافظ للتنمية ومنظور راديكالي للتنمية تختلف بشكل كبير في مقدماتها وعملياتها ونتائجها. وبحسبان طبيعة موضوع هذه الورقة فإن المقاربة المناسبة لتناول تحديات التعايش في ليبيا هي المقاربة التي تركز على مشاكل وتحديات بناء الدولة الحديثة الديمقراطية المدنية وتحقيق التنمية السياسية، وأعني بذلك منظور التحديث والتنمية السياسية الذي اهتم بشكل مباشر، عبر صياغته لمجموعة من الافتراضات والتصورات، بمحاولة تفسير أنماط تطور المجتمعات والدول المختلفة بصفة عامة، ومجتمعات ودول العالم الثالث بصفة خاصة، وتحولها الديمقراطي.
وقد اقترحت هذه الأدبيات أن أنماط التنمية والتحول الديمقراطي يمكن تفسيرها من خلال الطريقة التي واجهت بها الأمم والمجتمعات تحديات بناء الأمة وبناء الدولة وكيف قامت بحلها، وأطلقت على هذه التحديات تعبير الأزمات (Crises) وحددتها بخمس أزمات هي: الهوية والشرعية والتغلغل والتوزيع والمشاركة. (ألموند، صفحة 35) وقد ركزت أدبيات التنمية السياسية على تحديد كيفية تعاقب وتتابع هذه الأزمات وكيفية مواجهتها في المجتمعات المختلفة، وهل كان ذلك بطريقة متزامنة أم في فترات متعاقبة، وإذا كانت قد واجهتها في فترات متعاقبة فكيف كان ترتيب هذا التعاقب. وعلى أساس التحليل المقارن، اقترحت الأدبيات أن التعاقب الأمثل في مواجهة المشاكل هو معالجة مشكلة الهوية ثم الشرعية ثم التغلغل ومن بعدها التوزيع والمشاركة، كما تبيّن أن حل إحدى هذه الأزمات في فترة زمنية معينة لا يمنع إمكانية بروزها من جديد في فترة زمنية لاحقة حسب تغير الظروف والأحداث. (هنتنجتون، صفحة 186)
وغني عن البيان، أن الأوضاع الحالية في ليبيا تشي بغياب يكاد يكون كاملا لمؤسسات الدولة وعوز تام للأمن والقانون وبالتالي للسلم المجتمعي والآمان الأهلي، وأن المجتمع والدولة الليبية تواجه الآن معظم أزمات بناء الدولة في وقت متزامن ما يفاقم تأثيرها ومترتباتها. فالملاحظ أن هناك تساؤلات كثيرة حول الهوية، ومشاكل ملحة حول الشرعية، وعوز واضح في تغلغل مؤسسات الدولة، وعجز كبير في قدرات الدولة التوزيعية، وشكوك حاضرة حول جدوى المشاركة السياسية وتأثيرها على القرار السياسي واتجاهاته.
1- أزمة الهوية
يعتمد نجاح النظام السياسي في مواجهة تحديات التنمية والتحول الديمقراطي في قدرته على خلق درجة عالية من الاندماج الأفقي، أي بناء الأمة أو تشكيل هوية وطنية مشتركة من مجموع الهويات الطائفية والعرقية والجهوية والقبلية الأولية. ولا يعني وجود الهوية الوطنية وعلويتها على سواها من الهويات الأخرى بالضرورة إلغاء أو إقصاء أو تجاهل أو هجر كل مصادر الانتماء الأخرى، بل يعني ضرورة استيعابها ضمن إطار الانتماء والهوية الوطنية. ما يميز الهوية الوطنية عن الهويات الأخرى جمعيها أنها هوية عامة وجامعة ترتبط بالكيان السياسي للدولة، بينما الهويات الأخرى هويات جزئية تحت-وطنية. فلا سبيل لترسيخ العمليات السياسية الديمقراطية إلا إذا اقتصرت أهمية وتأثير الولاءات العرقية والطائفية والجهوية والقبلية على المجال الخاص، وسادت قيم الالتزام بمواطنة عامة ومشتركة. لأنه عندما تكون الانقسامات العرقية والطائفية والجهوية والقبلية حادة وعميقة وعنيفة، لا يكون هناك معنى للهوية السياسية المشتركة، وتصبح عملية الدمقرطة أمراً عصيا.
ولقد برزت أزمة الهوية الوطنية الليبية منذ تأسيس الدولة الليبية الحديثة عام 1951. فلقد كان مفهوم الهوية الوطنية الليبية غائما، وكانت هناك ضرورة ملحة لتشكيل مثل هذه الهوية بصورة تتجاوز الهويات المحلية والمناطقية والقبلية السائدة آنذاك. وكانت الأداة المناسبة للقيام بذلك هي المؤسسة التعليمية. والتعليم مهم جدا وأساسي لأي دولة. وتبرز أهميته من كونه وسيلة للتنشئة والتوحيد في الوقت نفسه. وتشير دراسات التنشئة السياسية إلى أنه من الأسباب الرئيسة للاهتمام بالتعليم هو خلق الإحساس بالهوية الوطنية والانتماء للدولة ومؤسساتها. وقد عملت المؤسسة التعليمية في ليبيا، عبر المقررات الدراسية، خاصة مقررات العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية المصرية التي كانت تُدرس في المدارس الليبية معظم فترة العهد الملكي، على غرس قيم ورؤى النظام الناصري حول القومية العربية والوحدة العربية، وبالتالي تكونت هوية قومية ترتبط بالأمة العربية بين الأجيال الطالعة. ولم يكن هناك تركيز على الهوية الوطنية الليبية إلا في فترة متأخرة من العهد الملكي (1968) أثناء حكومة عبد الحميد البكوش. (المغيربي، 1993، صفحة 52)
وهكذا، كان تشكُل الهوية، من منظور الهوية الوطنية الليبية الجامعة، تشكلا شائها حيث تكونت الولاءات والانتماءات من عناصر مناطقية وجهوية وقبلية تحت-وطنية ومن مكونات قومية وإسلامية فوق-وطنية. ولم يكن ذلك ضمن هوية وطنية ليبية جامعة، بل على حسابها وضدها في كثير من الأحيان.
ولقد أطلت هذه الأزمة برأسها من جديد هذه الأيام. فقد أثارت الانقسامات على المستوى النخبوي التي شاعت بعد ثورة فبراير فتنا واحترابات ما فتئت تسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي. فسؤال الهوية، في الحالة الليبية، لم يحسم بعد، أقله على مستوى النخب السياسية والفاعلين على الأرض. ويتضح ذلك على سبيل المثال من الانقسامات الحالية في المجتمع الليبي بين جماعات ومناطق تتمسك بهوياتها المحلية وتجعل لها الأولوية على الهوية الوطنية الليبية، وبين جماعات التطرف الإسلامي التي ترفض الاعتراف بالهوية الوطنية والدولة الليبية من الأساس وتدعو إلى هوية إسلامية فوق-وطنية. ومع تشبث كل طرف بمواقفه واستعداده لتوسل العنف تحقيقا لغاياته، يصبح الحديث عن التعايش المجتمعي والسياسي وحظوظه في التحول إلى واقع عيان يكاد يكون ترفا أكاديميا زائدا.
ويضاف إلى ذلك أن عمليات التنشئة السياسية خلال العقود الأربعة الأخيرة أنتجت ثقافة سياسية شائهة تتميز بوعي سياسي متخلف وميول تخوينية إقصائية. وتبرز أهمية ذلك من حقيقة أن الثقافة السياسية تشمل ضمن مكوناتها توجهات الأفراد حول الأفراد والجماعات الأخرى وحول أنفسهم كأعضاء في جماعة. فهل ينظر الأفراد إلى المجتمع على أنه منقسم إلى طبقات اجتماعية أو جماعات جهوية أو نجمعات عرقية؟ وهل يعبرون عن انتمائهم لشيع أو أحزاب بعينها؟ وما مشاعرهم تجاه الجماعات التي لا ينتمون إليها؟ إن مسألة الثقة بالجماعات الأخرى ستؤثر على الرغبة في العمل مع الآخرين من أجل أهداف سياسية وعامة، إلى جانب تأثيرها على رغبة النخب والزعماء في تشكيل تحالفات وائتلافات مع الجماعات الأخرى. (ألموند وآخرون، صفحة 109)
2- أزمة الشرعية
ليس في وسع أي مجتمع ديمقراطي أن يستمر طويلاً ما لم يكن يتمتع بشكل من أشكال الشرعية. والشرعية مفهوم يصعب تحديده وقياسه، غير أنه يمكن فهمه بصورة أفضل إذا ما جُزئ إلى ثلاثة مكونات: (أبو شهيوة، صفحات 98-99)
الشرعية الجغرافية: وتعني أن الذين يعيشون ضمن نطاق الدولة يقبلون حدودها الإقليمية أو لا يعارضونها إلا عبر الوسائل الدستورية. إذا لم يحس الأفراد والجماعات بشرعية الإطار الجغرافي للدولة فسوف تتعرض العمليات السياسية الديمقراطية للتهديد، وفي الحالات المتطرفة قد يأخذ التهديد شكل حركات انفصالية. وعندما لا تتوفر للجماعات وسائل ديمقراطية لتحقيق الانفصال، فمن غير المحتمل أن يلتزموا بالعمليات الديمقراطية، ويصبح العنف أمراً محتما تقريباً. وفي ليبيا، ظهرت دعاوى إرهابية متطرفة ترفض فكرة الدولة، بل ترفض عملية التحول الديمقراطي بمجملها. وبسبب عمليات التهميش التي مارسها النظام السابق، واستمرارها بعد ثورة فبراير، ظهرت دعاوى انفصالية. وفي الحالين، ثمة تشكيك صريح أو مضمر في شرعية الإطار الجغرافي للدولة والهوية الوطنية المشتركة.
الشرعية الدستورية: وتشير إلى القبول العام للقواعد التي تحدد تنظيم وتوزيع القوة السياسية والتنافس عليها. ويمثل تأسيس القواعد الدستورية أحد أصعب جوانب عملية الدمقرطة لأن عملية التحول الديمقراطي تفتح المجال لمدى واسع من المصالح المتنوعة والمتعارضة، وكل مجموعة تسعى لمعرفة كيفية تأثير الترتيبات الدستورية الجديدة على مصالحها وضمان حماية هذه المصالح. وتعكس الأحداث الأخيرة وصراعات الهيأة التأسيسية عمق الخلافات حول طبيعة الترتيبات الدستورية ونوع نظام الحكم المنشود- فيدرالي أم غير فيدرالي، ملكي أم جمهوري، برلماني أم رئاسي- وغيرها من الخلافات التي تكاد تعصف بمكونات العيش المشترك.
الشرعية السياسية: وتشير إلى المدى الذي يعتبر المواطنون وفقه أن لدى السلطات القائمة الحق في تولي السلطة. ويمكن إقرار أن الحكومة تتمتع بشرعية سياسية عندما تعكس نتائج الانتخابات التنافسية تفضيلات الناخبين وفقاً للقواعد والترتيبات الدستورية والمؤسسية. "غير أننا لا نعدم وجود من يشكك في أحقية نظام الحكم القائم في المرحلة الانتقالية في تولي السلطة لمجرد أن حزبه أو عشيرته أو ميلشيته لم يرض على توليه إياها. في زمن الاضطرابات الأمنية لا تكفي تفضيلات الناخبين لتحديد القائمين على إدارة الدولة، وحين تخسر بعض التيارات السياسية عبر صناديق الاقتراع، قد تلجأ إلى صناديق الذخيرة لتذود بها عن مصالحها. وقد بلغ هذا النوع من التشكيك في الشرعية ذروته حين رفض المؤتمر الوطني العام تسليم السلطة لمجلس النواب المنتخب، بما أفضى إليه ذلك من اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة، وما نتج عنه من وجود مجلسين تشريعيين وحكومتين تنفيذيتين تتنازع السلطة والشرعية. هذا إلى جانب الصراع حول الحوار والتوافق وحكومة الوفاق الوطني." (المغيربي والحصادي)
وعلى هذا النحو، يستبين أن مسألة الشرعية، بمختلف تجلياتها، قد تهدد بإجهاض عملية التحول الديمقراطي، بل بدخول البلاد في نفق قد يودي بها إلى الانضمام إلى قائمة الدول الفاشلة، وما لذلك من انعكاسات سلبية على إمكانات العيش المشترك.
3- أزمة التغلغل
يرتبط مفهوم التغلغل بقدرة الدولة على أداء وظائفها الاستخراجية والتنظيمية. وتنجم أزمة التغلغل عن عجز الدولة ومؤسساتها عن أداء وظائفها وممارسة أدوارها على كامل الامتداد الجغرافي للدولة وعلى كل المستويات وحيال كل الجماعات بصورة تتسم بالفاعلية والكفاءة. وبالنظر إلى أن المؤسسات الاستخراجية والتنظيمية تشكل أساس إدارة أي دولة حديثة، فإن تدني القدرات الاستخراجية والتنظيمية للدولة يحد من إمكانية التغلغل في المجتمع جغرافيا ووظيفيا، ويقلل من إمكانية سيطرتها وتنفيذ سياساتها العامة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
ويستبين حتى من النظرة السريعة الخاطفة للأوضاع الحالية في ليبيا تدني قدرات الدولة في مجالي الاستخراج والتنظيم، حيث توجد حكومات عاجزة عن الحكم، وسلطات تعوزها السلطة، ومجالس تشريعية غير قادرة على الحسم. ورغم الميزانيات الضخمة المخصصة والمصروفة، فشلت المجالس التشريعية والحكومات المتعاقبة في وضع حلول ناجعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ومعالجة مشاكل المركزية، ومواجهة الإرهاب، والتعامل مع انتشار السلاح.
ويمثل بناء الجيش الوطني إشكالية كبيرة تواجه سلطات الدولة. كما لا يجب الافتراض بأن الميلشيات المدنية المسلحة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ملتزمة بالضرورة ببناء الدولة أو الاقتصاد، لأن العديد من هذه الميلشيات المسلحة غير المنضبطة تعيش على الدولة وليس من أجل الدولة، وهذا أحد أسباب معارضة قادة هذه المياشيات والنخب السياسية المرتبطة بها لإعادة بناء الجيش الليبي وتفعيل وحداته العسكرية بذريعة أنها من بقايا جيش النظام السابق. وهذا المزيج من دولة لا تتغلغل وسلطات غير قادرة على بناء مؤسسة عسكرية قوية ومنضبطة يفسر الكثير من أزمات بناء الدولة والتعايش المجتمعي والسياسي التي تواجه الدولة الليبية. وقد كان لكل ذلك تأثير سلبي على ثقة المواطنين في مؤسسات المرحلة الانتقالية وقياداتها السياسية.
4- أزمة التوزيع
يُقصد بالأداء التوزيعي قيام مؤسسات الدولة بتخصيص مختلف أنواع السلع والخدمات والامتيازات والفرص للأفراد والجماعات في المجتمع. ويمكن قياس الأداء التوزيعي ومقارنته وفقا لحجم ما يتم توزيعه، ووفقا لمجالات الحياة الإنسانية المتأثرة بهذه المنافع، ووفقا للقطاعات السكانية المستفيدة من هذه المنافع، ووفقا للعلاقة بين الاحتياجات الإنسانية والتوزيعات الحكومية التي تهدف إلى الاستجابة لهذه الاحتياجات. ويعتمد الأداء التوزيعي للدولة على حجم الموارد ومصادر التمويل المتاحة لها. (ألموند، صفحة 289) وبحسبان أن ليبيا تنتمي إلى صنف الدول الريعية التي تعتمد بشكل أساسي على مورد ريعي وحيد وهو النفط، فسوف يتم التركيز في الجزء المتبقي من هذا القسم على السياسات الاقتصادية الريعية للدولة الليبية خلال العقود الأربعة السابقة لانتفاضة فبراير 2011 والسنوات التي تلتها.
ونظرا لأن النخب الحاكمة في ليبيا، خاصة بعد 1978، كانت هي صانع القرار الوحيد فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتوزيع والاستثمارات والأنشطة الأخرى، ولم تتركها لقوى السوق، فقد أدت السيطرة على الموارد الاقتصادية الريعية عبر السيطرة على مؤسسات الدولة إلى تعزيز قدرة هذه النخب على تكوين ثروات، وعلى استخدام سيطرتها على الدولة وهيمنتها على النشاط الاقتصادي لتوفير منافع لحلفائها وحرمان خصومها من الفوائد الاقتصادية. وقد نتج عن ذلك بروز اقتصاد ريعي مسيس حيث كان الكسب الاقتصادي الفردي نتاجا للوصول إلى، والقرب من، السلطة والقوة السياسية، وليس نتيجة لزيادة الإنتاجية والكفاءة والإسهام في مراكمة الثروة الاقتصادية للمجتمع. ولم تتميز السياسات الريعية بعدم الكفاءة الاقتصادية فحسب، بل قوضت أيضا شرعية الدولة وقللت من قبول عدم المساواة، وشجعت السلوك ضد- الاجتماعي والفساد المالي والإداري والسياسي. وفي مثل هذا المناخ المسيس جدا، ومع محدودية البدائل غير السياسية لتحسين المكانة والدخل، أصبح الصراع من أجل القوة والسلطة حادا وعنيفا في الغالب، وتمت عرقلة التنمية السياسية والاقتصادية ومأسسة عمليات بناء الدولة.
وقد استمرت النخب الحاكمة بعد فبراير 2011 في اتباع نفس السياسات الريعية للنظام السابق، واستخدمت الموارد النفطية في تشكيل التحالفات وتكوين الميلشيات، وأصبحت في واقع الأمر رهينة لهذه الميلشيات المسلحة، ووصل الفساد بكل أشكاله إلى مستويات غير مسبوقة. وقد أدى انخفاض أسعار النفط المتواصل منذ 2014 إلى تدني دخول الدولة الليبية بشكل ضخم وأثر بصورة مباشرة على أدائها التوزيعي وخلق أزمة توزيعية حادة أثرت على النشاط الاقتصادي وزادت من معاناة المواطنين. وأسهم عجز مؤسسات الدولة المنقسمة عن وضع السياسات الاقتصادية اللازمة لمواجهة هذه الأزمة وغيرها من الأزمات في تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ولقد أدى تزايد مستويات الفساد المالي والإداري والسياسي واستمرار النخب الحاكمة في الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي يؤمنها المنصب السياسي، دون أي اعتبار للظروف الاقتصادية الصعبة السائدة، إلى ارتفاع مستويات السخط الشعبي والإحساس بعدم شرعية سلطات الدولة.
5- أزمة المشاركة
بعد السابع عشر من فبراير فُتحت كل الأبواب وشُرّعت كل النوافذ أمام المشاركة السياسية والاجتماعية، وكان ارتفاع التوقعات واتساعها بقدر ارتفاع السموات واتساعها، وتشكلت الأحزاب السياسية وتنامت منظمات المجتمع المدني وأُجريت الانتخابات المحلية والوطنية والتأسيسية. إلا أن عقود التصحر السياسي وحظر الأحزاب وتقييد منظمات المجتمع المدني وغياب الانتخابات ألقت بظلالها المعتمة على الساحة السياسية وأنتجت أحزابا شائهة، ومنظمات مجتمع مدني قاصرة، وانتخابات لم تترجم نتائجُها تطلعات الناخبين وطموحاتهم، وتصرفات وسياسات للنخب الحاكمة لم ترق إلى مستوى توقعات المواطنين.
فقد تأثرت الأحزاب الناشئة بفترات المنع والقمع الماضية وعوز الخبرة بالعمل الحزبي والسياسي العلني، فهي تعاني ضعفا تنظيميا في إدارتها، وتفتقر إلى مشروع سياسي واضح المعالم، وإلى قاعدة اجتماعية حقيقية، وهي لذلك عاجزة عن تأدية دور الفاعل السياسي والاجتماعي القادر على إنجاح عملية التحول الديمقراطي، وإعلاء الصالح العام بالقطع مع القبيلة والغنيمة والعقيدة. أيضا فإن الأحزاب التي نشأت حديثا عكست دينامية تصارعية عقدت المشهد وجعلت الوصول إلى توافقات وتسويات صعبا. وبسبب سوء أداء الأحزاب، الذي يرجع أساسا إلى حداثة تجربتها، تنامى توجه مؤداه أن مناط الخلل في الأداء السياسي هو فكرة التعددية الحزبية نفسها، فظهرت دعاوى مناوئة لهذه الفكرة، تُرجم بعض منها عيانا في قانون انتخابات الهيئة التأسيسية وقانون انتخابات مجلس النواب وتتوج أخيرا في مسودة لجنة العمل للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بمنع الأحزاب السياسية لمدة أربع سنوات من بدء العمل بالدستور الليبي الجديد. وغني عن البيان أن مثل هذه النظرة السلبية لمفهوم التعددية الحزبية ولأداء الأحزاب إنما تسهم بدورها في عرقلة التحول الديمقراطي، وتحول دون التوافق النخبوي على السياسيات العامة. (المغيربي والحصادي)
وفي حين أن معظم أدبيات التحديث والتنمية السياسية والتحول الديمقراطي تتفق على أن وجود مجتمع مدني قوي وفاعل من العوامل الداعمة للنظام الديمقراطي، وعلى الرغم من بروز أعداد ضخمة من منظمات المجتمع المدني في ليبيا بعد ثورة فبراير، فإن المجتمع المدني في ليبيا يعاني من الكثير من الاختلالات الناجمة عن تجربة العقود السابقة، وأهم هذه الاختلالات هيمنة الدولة والتبعية التمويلية. فقد كانت الدولة مهيمنة بشكل كامل على المجتمع المدني حيث إن النقابات والاتحادات والروابط المهنية والجمعيات التطوعية الأهلية تُنشأ وتُنظم ويعاد تنظيمها وحلها بقرارات ولوائح وقوانين من الدولة، كما أن منظمات المجتمع المدني لم تكن مجالا مستقلا ومنفصلا عن الدولة، بل كانت متضمنة في البنية التنظيمية الرسمية وتعتبر جزءا من آليات النظام السياسي الليبي آنذاك. من جانب آخر، فإلى جانب خضوع المجتمع المدني تنظيميا وسياسيا لهيمنة الدولة فإنه كان خاضعا لسيطرتها التمويلية الأمر الذي قضى على استقلاليتها وفاعليتها وقدرتها على القيام بدور إيجابي في العملية السياسية. وعلى الرغم من الفرص المتاحة الآن للمجتمع المدني لتوكيد استقلاليته التنظيمية والتمويلية، غير أن المعضلة تتمثل في أن العقود الطويلة من خضوع هذه المنظمات لهيمنة الدولة واعتمادها شبه الكامل على تمويل الخزانة العامة، صعّبت عليها تأمين تمويل لنشاطاتها من مصادر ذاتية مستقلة. أضف إلى ذلك أن عقلية الاعتماد على الدولة، أي "العقلية الريعية"، السائدة في المجتمع الليبي تساعد على استمرار سعي المجتمع المدني لتأمين تمويل الدولة لنشاطاته، غافلا عن أو متجاهلا القيود التي يفرضها هذا التوجه على استقلالية المجتمع المدني وفاعليته. (المغيربي، 2002)
وإذا كانت الانتخابات التنافسية تمثل المظهر الرئيس لمشاركة المواطن الفرد في العملية السياسية، فإن انعدام خبرة المواطن الليبي بهذه العملية، نظرا لأن آخر انتخابات أُجريت في ليبيا كانت انتخابات مجلس النواب عام 1965 أثناء العهد الملكي، ألقت بظلالها على الانتخابات التنافسية المحلية والوطنية التي نُظمت في ليبيا منذ العام 2012، وخاصة في ما يتعلق بحسن اختيار الناخب الليبي لممثليه في المجالس المنتخبة. وعلى الرغم من أن هذا كان متوقعا في ضوء هذه الظروف، وأن اكتساب الخبرة عبر تكرار المشاركة في العملية الانتخابية سوف يُسهم إلى حد كبير في اختيار الممثلين ذوي الخبرة والكفأة بدلا من أن يكون الاختيار على أسس قبلية أو جهوية أو شخصية، فإن سوء أداء المجالس المنتخبة على كل المستويات وعجزها عن حل كل المشاكل الاقتصادية والأمنية، فضلا عن تدني قدرات سلطات الدولة في الاستخراج والتنظيم والتغلغل والتوزيع، إلى جانب صراعات النخب السياسية الحاكمة وانقسامها، انعكس بشكل سلبي على فكرة الانتخابات ذاتها وأدى إلى تنامي مشاعر العزوف عن المشاركة في الانتخابات، بل وتزايد النزوعات إلى رفضها، والدعوة لوجود قيادة سياسية وعسكرية قوية تقود البلاد في هذه المرحلة، وتحولت التوقعات المرتفعة إلى إحباطات متزايدة. وكل هذه مؤشرات سلبية حول احتمالات التحول الديمقراطي وحظوظ التعايش المجتمعي والسياسي.
خلاصة القول: نتج عن السياسات الريعية للدولة الليبية خلال العقود الخمسة الماضية ترسخ "العقلية الريعية" بين مختلف النخب والجماعات التي أصبحت تنظر إلى السيطرة على الدولة بمنطق الغلبة والغنيمة وبوصفها السبيل الوحيدة لتحقيق أهدافها ورغابها على حساب الأفراد والجماعات الأخرى. وكان من الحتمي، نتيجة لذلك، أن صارت العلاقات بين مختلف النخب والجماعات علاقات تصارعية وصفرية، وأصبحت الدولة مركز ومحور الصراع وليس مجرد كونها الهيئة التي تنظم التنافس بين النخب والفئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتضبط حدوده وأدواته. وحسبنا للتمثيل على مظاهر انقسام النخبة السياسية في ليبيا أن نذكر التشريعات الإقصائية، كقانون العزل السياسي، وعمليات التخوين المتبادل، والفشل في الاتفاق على السياسات العامة، والمواقف المتضاربة من دمج التشكيلات المسلحة وبناء الجيش والشرطة.
وفي ظل مثل هذه الأوضاع يصبح من الصعب أن يكون هناك اتفاق عام على قواعد العمليات السياسية والالتزام بها، خاصة بين النخب السياسية. ومن غير المحتمل أن تقبل أي مجموعة قواعد العملية الانتخابية إذا كانت هزيمتها تضر بمصالحها ضرراً كبيراً. وهذا يعني أنه إذا كان على الخاسرين القبول بنتائج العملية الانتخابية الديمقراطية، فإنه يتعين على الفائزين أن يقبلوا أن هناك قيوداً مهمة على ما يستطيعون فعله بقوتهم الجديدة. ووفقاً لهذا العامل، يعتمد ترسيخ الديمقراطية على ممارسة الأطراف الفائزة الاعتدال ومراعاة بعض القيود عند وضع السياسات العامة المختلفة. وفي واقع الأمر، يلزم أن يتم الاتفاق على القيود المفروضة على تغيير السياسة العامة قبل اكتمال عملية التحول الديمقراطي، أي أثناء المرحلة الانتقالية. (المغيربي والحصادي)
واقع الحال، أن أزمات الهوية والشرعية والتغلغل والتوزيع والمشاركة في حالة ارتهان متبادل، تؤثر وتتأثر ببعضها البعض وتنعكس على عمليات بناء الأمة وبناء الدولة ومن ثم، وبالضرورة، على احتمالات التعايش المجتمعي والسياسي. فمن ناحية، يرتبط الأداء الاستخراجي والتنظيمي للدولة بشكل وثيق مع أدائها التوزيعي، فالدولة لا تستطيع ممارسة وتوسيع قدراتها ووظائفها التوزيعية إلا بالقدر الذي تسمح به قدراتها الاستخراجية والجبائية والتنظيمية. وبدون شك فإن شرعية الدولة ومؤسساتها تتأثر بشكل مباشر بأدائها الاستخراجي والتنظيمي والتوزيعي. من ناحية أخرى، فإن للشرعية علاقة آصرة مع الهوية من حيث إن شرعية الدولة تتأثر، سلبا وإيجابا، بمدى تشكل هوية وطنية مشتركة تشعر من خلالها كل الأعراق والطوائف والقبائل والمناطق بانتمائها لكيان سياسي واحد يجمعها معا دون إقصاء أو تمييز أو تهميش. وكذلك، فإن تقييد فرص المشاركة في العملية السياسية أو إحساس المواطنين والجماعات بعدم جدواها، نظرا لسوء أداء مؤسسات الدولة وقياداتها ونخبها السياسية ولشعورهم بعدم قدرتهم على التأثير على محتوى واتجاه السياسات العامة، قد يؤدي إلى العزوف عن العملية السياسية، أو الأسوأ من ذلك، توسل العنف ضد الدولة والجماعات الأخرى أداة لتحقيق هذه الجماعة أو تلك. وما يترتب عن ذلك من عواقب سلبية بالنسبة للتحول الديمقراطي والتعايش المجتمعي والسياسي.
زاهي بشير المغيربي
ـــــــــــــ
المراجع
• أبو شهيوة، مالك (2016)، "تحديات بناء الدولة ما بعد الدكتاتورية ومتطلبات نجاح عملية التحول الديمقراطي ’الحالة الليبية‘"، مجلة عراجين، الإصدار الثاني، العدد التاسع، صفحات 67-107.
• ألموند، جبرائيل (1987)، "تطور دراسات التنمية السياسية"، في محمد زاهي بشير المغيربي (مترجم ومحرر)، التنمية السياسية والسياسة المقارنة: قراءات مختارة، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، 1998، صفحات 29-78.
• ألموند، جبرائيل وآخرون (1996)، السياسة المقارنة: إطار نظري، ترجمة محمد زاهي بشير المغيربي، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس.
• محفوظ، محمد (2014)، "التعايش من منظور مختلف"، جريدة الرياض، النسخة الإلكترونية، العدد 16710، 25 مارس 2014.
• المغيربي، محمد زاهي بشير (1993)، "التحديث وشرعية المؤسسات السياسية: النظام الملكي الليبي، 1951-1969"، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، المجلد 21، العدد الثالث/الرابع، خريف/شتاء 1993، صفحات 37-56.
• المغيربي، محمد زاهي (2002)، "الدولة والمجتمع المدني في ليبيا"، مجلة المؤتمر، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، العددان الثامن والتاسع، سبتمبر وأكتوبر 2002، صفحات 20-27.
• المغيربي، زاهي والحصادي، نجيب (2014)، "التحول الديمقراطي في ليبيا: تحديات ومآلات وفرص"، بحث مقدم لأعمال ندوة حول الانتقال الديمقراطي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تونس، مارس 2014.
• هنتنجتون، صاموئيل (1971)، "تطور دراسات التغيير: التحديث والتنمية السياسية"، في محمد زاهي بشير المغيربي (مترجم ومحرر)، التنمية السياسية والسياسة المقارنة: قراءات مختارة، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، 1998، صفحات 149-199.