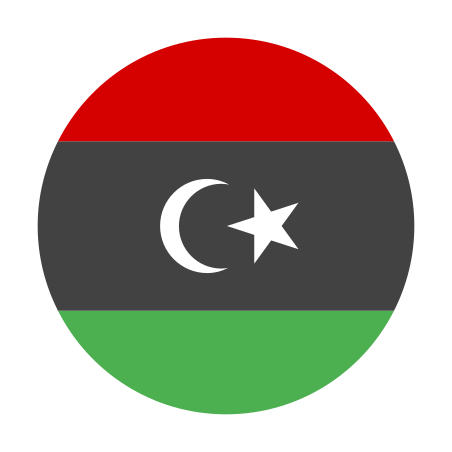بانوراما إبستيمية*
عبر التاريخ، دأب الإنسان على اللجوء إلى السماء، تارة ليحمّلها أعباء عيشه على وجه الأرض، وأخرى ليطلب مساعدتَها في حملها عنه. غير أنه ما فتئ يعود إلى الأرض، كما لو أن الحنين يعصف به إلى طين كان جبل منه. وقد ظل مراده في الحالين فهمَ العالم والسيطرةَ على مقدراته، وإن توسّل في تحقيق هذين المرادين أساليب عديدة ومتنوعة.
ففي البدء، ألقى السحرة بعصيّهم يستجدون عطايا السماء، بعد أن قرّ في أنفسهم أنها موطن أرواح تتحكم في مصائر البشر. ثم ألقى المؤسطرون بنظراتهم إلى السماء، محلقين في فضاءات الخيال، بعد أن وجدوا فيها سلوانا يبدّد مخاوفهم من الطبيعة، وموئلا للإجابة عن أسئلة استعصت عليهم. فيما ظلت سماوات الخيال محجة للفنانين، ومعين أعمال يشاكسون بها الواقع ويقاومون قبحه وجَوره؛ مرّ علقمه وأجاج ملحه.
ومع نزول الأديان، لجأ الإنسان مرة أخرى إلى السماء، فالتمس في الكتب المقدسة مصدرا لمعارفه، واستمر الأمر معه على هذا الحال ردحا طويلا من الزمن، بل استمر مع بعض الأمم إلى يوم الناس هذا. ومن الرمزيات اللافتة على هذا الصنف من الصعود صوب السماء، رفعُ الله مسيحَه، ومعراجُه بحبيبه إلى سدرة المنتهى.
وبدءا من القرن الثالث قبل الميلاد، تمظهر أول إعمال صريح للعقل عند سقراط في إنزاله الفلسفة من السماء إلى الأرض، بتحوّله من البحث في القضايا الميتافيزيقية إلى البحث في قضايا الإنسان. وعلى الرغم من أن أفلاطون عرج بطريقته إلى السماء، متمثلة هذه المرة في عالم المثل، ظل أرسطو متشبثا بالأرض، بتوكيده العقل والحس بوصفهما الحاستين الأقدر على معرفة ما يعتمل في الكون من ظواهر وأسرار، وما يحكمه من نواميس ومبادئ.
وغالبا ما تماعى إعمال العقل مع الزعم بمركزية الإنسان في علاقته بسائر الكائنات، وبمركزية الأرض في علاقتها بسائر الأجرام. وقد استبين هذا في الفلسفة والدين عبر مثنوية السماوات والأرض، واستبين في علم الفلك عبر نظرية بطليموس، التي سيطرت على الفكر البشري ما يربو على ثلاثةَ عشر قرنا.
غير أننا عدنا ثالثة إلى سديم السماء، من خلال فلسفات القرون الوسطى، وعلمي الكلام واللاهوت، حيث الأولوية للنقل على العقل، فلم يكد يُستثنى من ذلك غير المعتزلة، الذين أكدوا علوية العقل، وابن رشد، الذي أثّر في تدشين عصر الأنوار في أوربا، حتى قال بيير بيل أحدُ أبرز مؤسسيها إن مذهب باروخ اسبينوزا الذي أسس لهذا العصر مجرّدُ رشدية معدلة.
وفي القرن السادس عشر انبلج العصر الحديث على يد رينيه ديكارت بجعله اللجوء إلى الله في قباب سمائه ضامنا سرمديا لقدرة الإنسان في أقبية الأرض على معرفة العالم؛ غير أنه أشاح في النهاية بوجهه عن السماء، حين حاول التأسيس للمعرفة العلمية، وحين ارتأى أنه نجح في الردّ على الشكاك والملاحدة؛ وأن هذا يعطيه الحق في إناطة مهمة فهم العالم بالمعامل بعد أن كانت هذه المهمة منوطة بالمعابد.
ثم جاء جون لوك الذي تبنّى أسلوبا لا شريك له في التشبث بالأرض، تمثّل في التعويل على الحس دون غيره من ملكات، فأنكر الأفكار الفطرية، أقوى سندات اللاهوت، وأحيا مقولة أرسطو أن ليس في النفس ما لم يكن من قبل في الحس، فتكرست نزعةٌ إمبيريقية مارست سطوتها ما يربو على أربعة قرون.
ثم جاء المرتاب ديفيد هيوم، ليبعث تقليد الشكاك، بيرون وأريسكلاوس وإمبيريكوس، ويعلن أنه لا عون معرفيا يرتجى من أرض ولا سماء، وأنه لا خيار لدى الإنسان سوى تعليق الأحكام، ولا رصيد لديه غيرُ سراب الأوهام.
ومن بعده جاء إمانويل كانط ليجمع بين ملكتي الحس والعقل، وحين سئل عمن يجب علينا اللجوء إليه حين تختلط علينا الأمور، أجاب بأن ما لا يرتد إلى أصول حسية غير قابل ابتداء لأن يعرف، فدقّ بذلك أول مسمار في نعش الفلسفة، الذي لن يلبث حتى يرقُد فيه جثمان مذهبه شخصيا – فهو مثل أي مذهب فلسفي آخر لا يرتد إلى أصول حسية – فصحّ عليه قول بيتر ستراوسن إنه حاول رسم دائرة المعرفة من نقطة ما كان لها أن توجد لو أنه أحسن الرسم.
وقد أسهم إمانويل كانط، ومن قبله باروخ اسبينوزا وبيير بيل، ومن بعدهم فرانسوا فولتير وسائرُ رجالات التنوير، في إعادة الاعتبار إلى مكانة الإنسان بتوكيد أهمية العقل الذي يتفرد به عن سائر كائنات الكون. ومنذ مطلع القرن العشرين، ولما يربو على سبعة عقود، سيطرت الوضعية المنطقية، التي وجدت في العلم أوج مراتب العقلانية، واعتبرته المصدر الوحيد للمعرفة، وأنكرت وفق مبدأ التحقق الأديان قاطبة، والميتافيزيقا بأسرها، والأخلاقَ برمتها، ليس بسبب عجز البشر عن معرفة أحكامها، كما حسب كانط، ، بل لأنها ليست أحكاما أصلا، ما يجعلها خلوا من أي معنى، ولا الله ولا الشيطان، على حد تعبير رودلف كارناب، يعرف ما لامعنى له. وحين واجه الوضعيون مشكلة شبيهة بمشكلة كانط - أن مذهبهم وفق مبدأ التحقق سوف يكون هو نفسه خلوا من المعنى - لم يعبؤا بها، بل اكتفوا بترديد قالة عرّابهم لودفيغ فتغنشتاين الشهيرة "إن من يفهمنا سوف يكتشف لامحالة أنه لا يفهمنا".
وفي الأثناء، ظل العلم يمارس هوايته المفضلة في إحداث صدمات تزعزع مكانة الإنسان في الكون؛ صدمة نيكولاس كوبرنيكوس التي جعلت الأرض مجرد ذرة في غبار سديم لا يكاد يتناهى؛ وصدمة سيغموند فرويد التي وكّدت دور غرائز جنسية وضيعة في تحديد مصير الإنسان؛ وصدمة تشارلز داروين الذي زعم أن الإنسان مجرد حيوان آخر يكافح من أجل البقاء؛ وصدمة كارل ماركس التي اختزلته إلى كائن تتحكم فيه حاجات غذائية صرف.
وكانت الشكوك حول قدرة العقل على فهم العالم قد ساورت الفلاسفة منذ عهود طويلة. فقد تساءل هيوم "أي ميزة خاصة يتمتع بها هذا القلق الصغير الذي نسمّيه الفكر، بحيث نجعل منه نموذج الكون بأسره؟"؛ وتساءل برغسون "أنى لصَدفة العقل التي ألقتها أمواج الحياة أن تتمثل صورة الأمواج التي ألقتها؟"؛ وأعلن بسكال من "أن للقلب أسبابا لا يعرفها العقل"؛ وحذّرنا طاغور من أن "العقل مدية كلها نصل" مآلها أن تدمي راحة من يمسك بها؛ أما روسو فقد آمن بوجود حياة أخرى لأسباب يعترف بأنه لم يملها عليه العقل، وعلى حد قوله، المعبّر عن تفكير رغبوي يحنَث صراحة باليمين السقراطي، "لقد عانيت في هذه الحياة حدا جعلني أثق في حياة أخرى، وليس ثمة حذق ميتافيزيقي بقادر على أن يجعلني أشك لحظة في العناية الإلهية، فأنا أشعر بها، أعتقد فيها، أريدها، آمل فيها، وسوف أدافع عنها إلى أن ألفِظ أنفاسي الأخيرة".
وقد رسخت مدارس العبث والدادائية وما بعد الحداثة عنصر اللامعقولية الذي يكتنف الظرف البشري بأساليب مختلفة، لكنها أجمعت على تسفيه محاولات التأسيس، والثقة المطلقة بالعقل، والسرديات الكبرى، وشكّكت في جدوى الحديث عن القيم، وأنكرت البحث عن معنى للحياة. وحسب جيل ديلوز، حتى المعنى مصطلح مشبوه، لأنه يفترض أن شيئا بعينه يمكن أن يمثّل شيئا آخر أو يقوم مقامه، في حين أن الأشياء هي نفسُها فحسب، وليست علاماتٍ على أشياءَ أخرى غامضة، ومثنوية السطوح والأعماق مجرد ميتافيزيقا بالية عفّ عنها الزمان.
وكان المبدأ الحتمي العقلاني قد بدا لدى البعض غاية في البداهة، وقد عبّر عنه لابلاس بقوله "إن المفكر الذي يعرف في أي لحظة كلَّ القوى التي تبُث الحياة في الطبيعة والمواضعَ المتبادلة التي تتخذها كائناتها، سوف يستطيع أن يكثف في معادلة واحدة حركة أعظم أجرام الكون وحركة أخفِّ ذراته؛ وسوف يكون العالم بأسره ماثلا أمام عينيه." وهكذا أضمر المثال اللابلاسي وعدا بالمعرفة الكلية، وعدا بفردوس اليقين، يرتهن البرّ به لتبني خيار العلم واستمرارِ الحياةِ الدنيا أبد الآبدين. هذا ما جعل الحتميين واثقين من أنه لا شيء يحول دون الدراية بكل شيء سوى فناء الجنس البشري. البشارة الحتمية إذن قاطعة لا مواربة فيه: إذا انتظرنا ما يكفي من الوقت، سوف نعرف كل شيء. وعلى حد تعبير آلبرت أينشتين، "إن أشد الأشياء استغلاقا على العقل هو أن العالم يمكن تعقله"، ما يعني أن كل شيء في الطبيعة قابل للفهم، باستثناء كونها قابلة للفهم.
ثم جاءت ميكانيكا الكم لتشكك في تلك البشارة. حتى لو استطاع البشر معرفة الأوضاع الراهنة في الكون، لن يتمكنوا من التنبؤ بمستقبله، إذ كلما كان الملاحظ أكثر دقة في قياس طاقة الحدث الكمومي، قلّت قدرته على تحديد زمنه؛ وكلما تسنىت له معرفة موضع الإلكترون، قل احتمال درايته بكمية حركته. ثمة إذن جهل مأتاه أن القياسات التي يقوم بها العلماء ليست تصورات خاملةً لعالم موضوعي، مفارقٍ ومعتصم باستقلاليته، بل تفاعلات عاملة يسهم فيها المقاس بقدر ما تسهم فيها الطريقة التي يقاس بها.
الواقع، إذن يتلعثم، وليس محددا بالقدر الذي حسبنا، والغموض لا يطال تمثلات البشر للواقع فحسب، بل يطال الواقع نفسه، والمستقبل سوف يظل دائما خفيّا ليس لأن قدرة الإنسان على المعرفة محدودة، بل لأن هناك شواشا كامنا في العالم نفسه، في بنيته التحتية، ولأن هناك هشاشة في مواضع في الكون بدت لقرون صلبة وأمنة بما يكفي.
وهكذا أعلن هايزنبرغ، من خلال مبدئه في اللاتيقن، أن عهد السببية العقلاني قد ذهب إلى غير رجعة وأن عالمنا شيء عارض تماما. ومفاد هذا المبدأ يختلف عن الحكم البدهي أن البشر يعرفون أشياء ولا يعرفون أشياء أخرى، كما يختلف عن الحكم الحتمي أنهم لو عرفوا أشياء لعرفوا كل شيء، فهو يقر أن معرفتهم بأشياء مأتى جهلهم بأشياء أخرى؛ كما لو أن العلم يحتم الجهل. وهو لا يقول، على طريقة كانط، إننا خلقنا على نحو يحول دون قدرتنا على فهم العالم، بل يقول إن العالم قد خلق على نحو يحول دون قدرتنا على فهمه. وهكذا استبين أن الطبيعة لاتلعب بالنرد فحسب، بل وترمي به إلى حيث لا يراه أحد؛ أو هكذا يزعم هاوكنغز.
أما المناقب التي ظلت العلوم الطبيعية تستعلي بها قرونا على العلوم الإنسانية، كالموضوعية والدقة والتحرر من الأحكام القيمية، فقد فقدتها فجأة، وفقدت معها مبرر نظرتها الدونية للإنسانيات. لم يعد هناك براح لليقين والإطلاق والجزم، لا في العلوم الإنسانية ولا في العلوم الطبيعية. يحدث هذا في العلم، معقل الملاحظة والتجريب وإعمال أشد معايير الاختبار صرامة وإحكاما وانضباطا؛ فما عسى أن يكون عليه الأمر حين يتعلّق بمسائل ميتافيزيقية أو أخلاقية أو سياسية؟ يظهر أن النزعات الدوغمائية تلقى مصارعها على يد ميكانيكا الكم، وأن بقاءها إلى يومنا هذا لا يثبت سوى عناد أنصارها.
ومع مطلع الألفية الثالثة جاءت صدمة الذكاء الاصطناعي، أحدث جهود إعمال العقل، والدافعة به إلى أقصى حدوده الممكنة. ومع الذكاء الاصطناعي لجأ البشر ثانية إلى السماء، التي نرمز إليها هذه المرة بالآي كلاود، أو السحابة المعلومتية، التي تخزَّن فيها معارف البشر وأدق خصوصياتهم. أما في مجال الفضاء فقد حدث معراج آخر إلى السماء، لكنه ليس معراج تمائم سحرة، ولا أحداس مؤسطرين، ولا خيالات فنانين، ولا رغاب فرعون في صرح يطلع به إلى إله موسى، بل معراج لا كناية فيه ولا مجاز؛ معراج بالروح والجسد يقوم به علماء مدجّجون بنظريات فلكية ومناظيرَ فائقة تطلعهم على ما يحدث في مجرات قصية؛ وتقلهم إليها مركبات فضائية تذرع السموات وتدشن مشروع أوطان في كواكب أخرى لكائنات ضاقت بهم الأرض بما رحبت. يبدو في نهاية المطاف أن الإنسان سيزيف الخليقة، يمضي سيرة وجوده، يروح ويغدو، بين أقبية أرض وقباب سماء.
* نص محاضرة أُلقاها الكاتب يوم السبت 13 يناير 2024 ضمن الموسم الثقافي لمركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي.